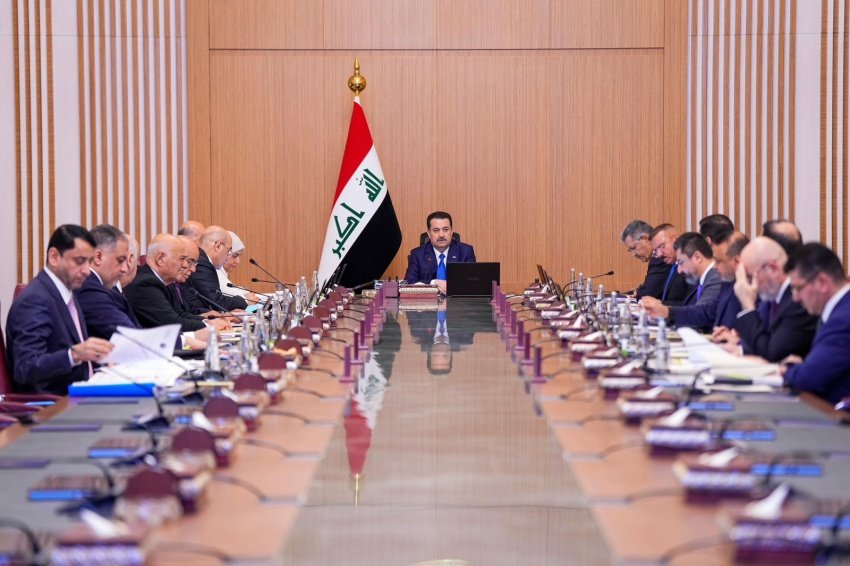+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
لا يكاد يمر نقاش في العراق من دون ذكر “الموظف الحكومي”؛ من حيث تضخّم في أعدادهم، رواتب تلتهم الموازنة، حديث متصاعد عن “صفر إنتاجية”، وتحذيرات من “انهيار الاقتصاد في عام 2030” إذا استمرّ الإنفاق على هذا النحو. في الخلفية، يقف اقتصاد ريعي يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط، وقطاع خاص هش، وسوق عمل يهرب شبابه إلى الوظيفة الحكومية باعتبارها الملاذ الوحيد شبه الآمن.
الفكرة السهلة تقول إنّ الحل يبدأ من الموظف وينتهي عنده: خفّضوا عددهم، قنّنوا رواتبهم، ادفعوا أعدادًا منهم نحو الإجازات الطويلة والتقاعد المبكر، وستتحسّن أرقام المالية العامة تلقائيًا. لكن قراءة أعمق للأرقام، ومعها شهادات خبراء في الاقتصاد والقانون، تكشف أنّ الصورة أعقد بكثير، وأنّ السؤال الحقيقي لا يتعلّق بعدد الموظفين فحسب، بل بطريقة إدارة الدولة نفسها، وبالعلاقة المتشابكة بين الوظيفة العامة وبنية الاقتصاد ككل.
فاتورة رواتب تكبر مع كلّ موازنة.. كيف وصلنا إلى هنا؟
خلال نحو عقدين، تحوّلت الدولة العراقية إلى أكبر ربّ عمل في البلاد. تقديرات رسمية ومحلية متطابقة تشير إلى أنّ ما يزيد على 4,000,000 موظف يعملون اليوم في مؤسسات الدولة المختلفة، ما بين وزارات ودوائر ممولة مركزيًا ومؤسسات في إقليم كردستان، فيما يرتبط دخل أكثر من 10,000,000 مواطن شهريًا بالخزينة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بين رواتب موظفين ومعاشات تقاعدية وشبكات حماية اجتماعية وإعانات متنوعة.
في أرقام الموازنات المتعاقبة، تظهر بصمة هذا المسار بوضوح. فاتورة الأجور وتعويضات الموظفين تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق التشغيلي، وتقترب في بعض التقديرات من حدود النصف مع إضافة التقاعد والحماية الاجتماعية، ما يعني أنّ الجزء الأكبر من المال العام يذهب إلى الصرف الجاري، بينما يتراجع هامش الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ومع كلّ زيادة في أسعار النفط أو توسّع في الإيرادات، غالبًا ما يُعاد تدوير الفائض في شكل تعيينات جديدة أو زيادات في الرواتب، لا في تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
هذا المسار لم يأتِ صدفة. فبعد 2003، استُخدم التوظيف الحكومي كأداة تهدئة اجتماعية وسياسية، وكوسيلة لامتصاص نقمة البطالة وشراء الاستقرار، أكثر مما استُخدم كأداة إدارة وتنمية. التعيينات الواسعة جاءت في كثير من الأحيان استجابة لضغوط سياسية وكتلوية، أو لتسويات داخلية، أو لالتزامات انتخابية، من دون أن تقابلها إعادة هيكلة حقيقية لمهام الدولة أو بناء جهاز إداري حديث. النتيجة كانت جهازًا متضخّمًا يتكوّن من وحدات مكتظّة بأعداد تفوق حاجتها الفعلية، وأخرى تعاني نقصًا في كوادرها، خصوصًا في الصحة والتعليم والخدمات المباشرة للمواطن.
“صفر إنتاجية”.. أسطورة بسيطة تخفي مشكلات معقّدة
في هذا السياق، أصبح من السهل تعليق كلّ أزمات الاقتصاد على الموظف الحكومي. تنتشر جداول “تقديرية” على منصات التواصل، تُقارن بين ما يتقاضاه الموظف من راتب وما يُفترض أن يقدّمه من ناتج، ثم تنتهي إلى جملة واحدة جذّابة: “إنتاجية الموظف تساوي صفرًا”.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد يدعو إلى الحذر في التعامل مع هذه العبارة. في حديثه لـ”بغداد اليوم” يوضح أنّ إنتاجية الموظف لا يمكن قياسها بالمقياس نفسه المستخدم في المصانع وخطوط الإنتاج، لأنّ الموظف الحكومي، في جوهر عمله، يقدّم “خدمة عامة” لا سلعة قابلة للعدّ. محاولة تحويل هذه الخدمة إلى رقم رياضي بسيط، كما يقول، تنتهي في الغالب إلى استنتاجات مضلّلة.
يقول محمد إنّ “إنتاجية الموظف العراقي في مؤسسات الدولة لا يمكن قياسها بالمعايير والقياسات التقليدية المتداولة، لأنّ الموظف الحكومي يقدّم خدمة عامة وليس خدمة إنتاجية بالمعنى الاقتصادي المتعارف عليه”، مبينًا أنّ “ما يطرحه البعض من أرقام وقياسات، لا سيّما الحديث عن أنّ إنتاجية الموظف تساوي صفرًا، هو طرح غير موضوعي وغير منطقي”.
ويضيف أنّ الموظفين “مكلّفون بإدارة شؤون الدولة وضمان استمرارية العمل والتواصل مع المواطنين، ولا توجد وحدات قياس واضحة يمكن من خلالها احتساب إنتاجية الموظف الحكومي”، مشيرًا إلى أنّ “العديد من موظفي دوائر الدولة يعملون حتى في أوقات العطل الرسمية لإنجاز واجباتهم، ما يؤكّد أنّ تلك الطروحات تفتقر إلى الدقّة والمسؤولية وتندرج ضمن إثارة الجدل فقط”.
هذا لا يعني تبرئة الجهاز الحكومي من الترهل، لكنه ينقل النقاش من إدانة الموظف كفرد إلى نقد بنية الإدارة نفسها. المشكلة الأولى تكمن في سوء توزيع القوى العاملة داخل الدولة، حيث تُكدَّس آلاف الوظائف في مكاتب وأقسام لا تحتاج إلى هذا الحجم من الكوادر، بينما تبقى مراكز صحية ومدارس ودوائر خدمية في أطراف المدن والقرى تعاني من نقص شديد في الأطباء والمدرّسين والمهندسين والفنيين. والمشكلة الثانية أنّ غياب الرقمنة وتحديث الإجراءات يخلق طبقات من العمل الورقي تسمح بوجود أعداد كبيرة من الموظفين يدورون في حلقة الروتين، بينما لو أعيد تصميم الخدمة وأتمتتها لظهرت حاجة فعلية إلى عدد أقلّ من الموظفين، لكن بأدوار أكثر تخصصًا ومسؤولية.
بهذا المعنى، يصبح الحديث عن “صفر إنتاجية” وصفًا عاطفيًا أكثر منه تحليلًا اقتصاديًا. نعم، الإنتاجية ضعيفة في مجالات عديدة، لكنّ المسؤولية موزّعة بين تصميم الوظيفة وطريقة الإدارة وبيئة العمل ونظام المتابعة والمساءلة، وليس على الموظف وحده بوصفه الحلقة الأضعف في هذا البناء.
2030.. نبوءة انهيار أم تحذير من مسار قابل للتغيير؟
على وقع تضخّم الرواتب واعتماد الدولة شبه الكلّي على النفط، راجت في السنوات الأخيرة نبوءة تقول إنّ “الاقتصاد العراقي سينهار في عام 2030”. البعض يتعامل مع هذا التاريخ كما لو أنّه قدر لا مفرّ منه، مستندًا إلى قراءة خطّية لمسار الموازنات والعجز المالي.
ضرغام محمد يصف هذا الخطاب بأنّه “غير مسؤول”، ويشير إلى أنّ انهيار الاقتصادات لا يحدث وفق مواعيد ثابتة على الورق، بل نتيجة تفاعل معقّد لعوامل داخلية وخارجية لا يمكن حصرها في سنة بعينها. يذكّر بأنّ تحذيرات مشابهة أُطلقت قبل نحو عشر سنوات، وأنّ الحديث عن “انهيار قريب” تكرر مرارًا، ومع ذلك بقيت الدولة قادرة على دفع الرواتب وتمويل جزء من التزاماتها، وإنْ بكلفة مديونية وضغوط متزايدة على هامش المناورة المالية.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل التحذير بالكامل. فالمسار الحالي يشير إلى أنّ استمرار تضخّم الإنفاق الجاري، وبقاء الإيرادات مرهونة بأسعار النفط، سيضيقان تدريجيًا هامش قدرة الدولة على امتصاص الصدمات. أي هبوط حادّ في أسعار النفط قد يتحوّل في لحظة ما من “أزمة عابرة” إلى تهديد مباشر لاستقرار الرواتب والخدمات الأساسية، إذا لم تُتخذ خطوات جدّية لتخفيف العبء عن الموازنة وتنويع مصادر الدخل.
الفارق بين الخطاب الدعائي والتشخيص الجاد أنّ الأوّل يحوّل 2030 إلى “تاريخ لنهاية العالم”، فيما يضع الثاني هذا التاريخ داخل مسار يمكن تعديله. إذا استمرّت السياسات كما هي، فالهامش المالي سيتقلّص، وقدرتنا على مواجهة الأزمات ستضعف، وحينها ستصبح أي صدمة في سوق النفط أكثر خطورة مما هي عليه اليوم. أمّا إذا بدأ إصلاح حقيقي، فيمكن تحويل هذه اللحظة من “نبوءة انهيار” إلى “ضغط إصلاحي” يجبر الدولة على إعادة بناء نمط الإنفاق والموارد.
الموظف الحكومي كملاذ اجتماعي.. حين يهرب الناس من السوق إلى الدولة
لا يمكن فهم تضخّم أعداد الموظفين من زاوية المالية العامة وحدها. الموظف الحكومي في العراق ليس رقمًا في جدول، بل تجسيد لعقد اجتماعي كامل بين المواطن والدولة. في سوق عمل هش، وقطاع خاص لا يوفّر غالبًا ضمانًا اجتماعيًا ولا استقرارًا وظيفيًا، تصبح الوظيفة في الدولة الخيار الأقرب لمن يبحث عن دخل ثابت وتقاعد مضمون وتأمين صحي نسبي.
بيانات سوق العمل تشير إلى أنّ نسبة كبيرة من قوّة العمل تشتغل في القطاع العام، بينما يتوزع الباقون بين وظائف في القطاع الخاص غالبًا غير منظّمة، وبين عمل غير رسمي وبطالة صريحة أو مقنّعة. في المقابل، مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت أقل بكثير من إمكانات البلد، وبيئة الأعمال تعاني من تعقيدات إجرائية وبيروقراطية وفساد، تجعل الاستثمار الجادّ في الصناعة والزراعة والخدمات عالية القيمة استثناءً لا قاعدة.
في ظلّ هذه المعطيات، يصبح الحديث عن “إعادة ترتيب أوضاع الموظفين” أو “تقليل أعدادهم” من دون خطة متكاملة لإنعاش القطاع الخاص وخلق وظائف لائقة فيه أقرب إلى المغامرة. كلّ موظف يُدفَع نحو التقاعد المبكر أو الإجازة الطويلة يعني أسرة تفقد جزءًا من أمانها المالي إذا لم يكن أمامها بديل حقيقي في سوق العمل، وكل تقليص في التعيينات من دون إصلاح بيئة الاستثمار يعني دفعة جديدة من الشباب نحو البطالة أو الهجرة أو العمل غير الرسمي.
هنا يتجلّى التناقض بوضوح: الدولة تريد تخفيف عبء الرواتب، والمجتمع ما زال يرى في الدولة ملاذه الوحيد. والحلّ لا يمكن أن يكون في كسر هذا الملاذ قبل بناء أرض جديدة يقف عليها الناس.
من “اقتصاد الحكومة” إلى “اقتصاد الدولة”.. أين يبدأ الإصلاح؟
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد يلخّص جوهر المشكلة في عبارة لافتة: المطلوب هو الانتقال من “اقتصاد الحكومة” إلى “اقتصاد الدولة”. في اقتصاد الحكومة، تختزل السلطة نفسها في دور الصندوق الذي يتلقّى عوائد النفط ويوزّعها رواتب ومنافع، وتختزل وظيفة الموظف في تسلّم الراتب نهاية الشهر وإنجاز الحدّ الأدنى من المعاملات. في اقتصاد الدولة، تصبح الحكومة عقلًا يدير الموارد، ويرسم السياسات، ويهيئ البيئة القانونية والمؤسسية لنموّ القطاع الخاص، من دون أن يتخلّى عن دوره في تقديم الخدمات الأساسية وحماية الفئات الهشّة.
على المستوى العملي، هذا الانتقال يعني إعادة تعريف دور الموظف الحكومي ذاته. في اقتصاد الدولة، يصبح الجهاز الإداري أصغر من حيث العدد، لكنه أكثر تخصصًا وكفاءة، يعمل في مجالات التنظيم والرقابة والتخطيط، ويقدّم خدمات لا يستطيع السوق القيام بها بمفرده، فيما تُترك مساحات أوسع للقطاع الخاص كي ينتج ويوفّر فرص العمل. في المقابل، تُلزَم منشآت القطاع الخاص بشمول العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، وتُفرَض قواعد تنافس عادلة، حتى لا يتحوّل تقليص التوظيف الحكومي إلى دفع الناس من “وظائف متعبة لكن مضمونة” إلى “أعمال بلا حقوق”.
إصلاح فاتورة الرواتب في هذا السياق لا يُختزل في إجراءات معزولة من نوع تجميد التعيينات أو تشديد ضوابط الإجازات، بل يصبح جزءًا من حزمة متكاملة تشمل إصلاح نظام الأجور، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات التي تشجّع القطاع الخاص على التوسّع. من دون هذه الرؤية المتكاملة، تبقى الإجراءات الجزئية أشبه بترقيع مؤقّت يدفع المشكلة إلى الأمام بدل حلّها.
اختبار للنظام السياسي قبل أن يكون معادلة مالية
الخبير في الشأن القانوني، علي السعداوي، يضع الموضوع في إطار أوسع من الأرقام والجداول. في حديثه لـ”بغداد اليوم” يرى أنّ ما يمرّ به العراق اليوم “لا يمكن النظر إليه بوصفه أزمة مالية فحسب، بل هو اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي على إعادة صياغة أولوياته في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة”.
يقول السعداوي إنّ الأزمات “تكشف مكامن الخلل البنيوي، لكنها في الوقت ذاته تفتح نافذة لإصلاحات جادّة إذا توفّرت الإرادة السياسية والجرأة في اتخاذ القرار”. ويضيف أنّ البلاد تقف الآن “أمام مفترق طرق”، فإمّا أن تتحوّل الضغوط الاقتصادية إلى دافع لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وإمّا أن تستمرّ إدارة المرحلة “بعقلية الترقيع المؤقّت”، بما يكرّس الجمود ويؤجّل الاستحقاقات الإصلاحية بدل مواجهتها.
ويشدّد السعداوي على أنّ المطلوب “ليس إجراءات آنية فقط، بل رؤية استراتيجية طويلة الأمد تضع الإنسان العراقي في صلب عملية التنمية، وتربط بين الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي”، معتبرًا أنّ هذه المرحلة “حساسة لكنها قد تكون فرصة تاريخية إذا أُحسن استثمارها”.
من إدانة الموظف إلى مساءلة النموذج كله
في المحصلة، يبدو من السهل تحميل الموظف الحكومي مسؤولية العجز والديون، والاختباء وراء عبارة “صفر إنتاجية” لتبرير كلّ شيء، غير أنّ نظرة أعمق تكشف أنّ الموظف ليس سوى المرآة الأوضح لنموذج اقتصادي وسياسي كامل قام لسنوات طويلة على ريع النفط وتوسيع التوظيف في الدولة بدل تمكين الناس من العمل المنتج.
المرحلة الراهنة لا تدور حول أعداد الموظفين بقدر ما تدور حول طبيعة الدولة نفسها في العقد المقبل؛ فإمّا استمرار دولة صندوق التوزيع التي تتلقّى الأموال من بيع النفط وتحوّلها إلى رواتب ومخصّصات، وإمّا تحوّل تدريجي نحو دولة إدارة وتنمية تعيد رسم دورها في الاقتصاد، وتفتح المجال أمام قطاع خاص منتج، وتُشرك المجتمع في تحمّل جزء من مسؤولية المستقبل ضمن قواعد واضحة وشفافة.
بين هذين المسارين يُعاد تعريف موقع الراتب، ودور الموظف، وحدود مساهمة القطاع الخاص، وتتبلور ملامح عقد جديد بين المواطن والدولة؛ عقد يمكن أن يبقى أسير معادلة “الراتب مقابل الولاء والصمت”، ويمكن، في المقابل، أن يتطوّر إلى شراكة أوسع تقوم على الكفاءة والعدالة والاستدامة، وتجعل من العمل العام جزءًا من مشروع تنموي طويل الأمد لا مجرّد بند ثابت في الموازنة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات